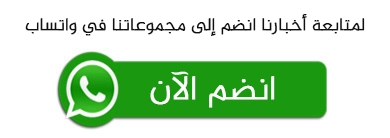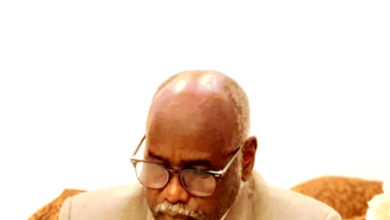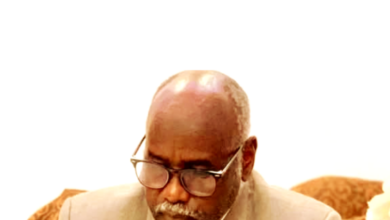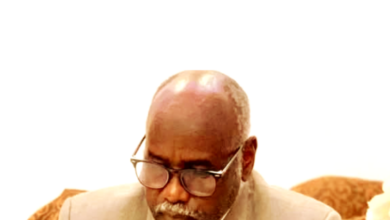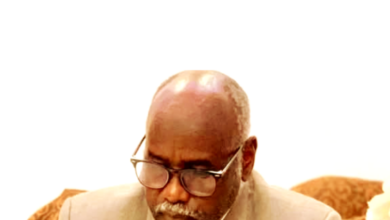عوض الكريم فضل المولى وحسن عبد الرضي يكتبان أنماط طرائق التفكير السوداني: السياسة السودانية بين الحداثة والموروث والتقاليد المحلية
متابعات- مرآة السودان

أنماط طرائق التفكير السوداني (٣١)
عوض الكريم فضل المولى وحسن عبد الرضي
السياسة السودانية بين الحداثة والموروث والتقاليد المحلية:
ان صراع الهويات ومسارات التحول جعلت المشهد السياسي السوداني يمثل أحد أكثر المشاهد تعقيدًا في المنطقة، ليس فقط نتيجة لتاريخه الطويل مع الانقلابات والنزاعات المسلحة، بل أيضًا نتيجة لصراع عميق بين تيارين متباينين: تيار يسعى للحداثة والتغيير وبناء دولة مدنية حديثة، وتيار آخر يتمسك بالموروث الثقافي والديني والتقاليد والأعراف المحلية التي تشكل بنية المجتمع السوداني. هذا التباين أوجد حالة توتر مستمر بين النخب السياسية والمجتمعات المحلية، ما جعل مشروع بناء دولة وطنية موحدة أكثر صعوبة وتعقيدًا. إذ يظهر الحضور الطاغي للهويات المحلية، فالسودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والديانات، وتشكل الأعراف والتقاليد القبلية والروحية بنية أساسية للحياة الاجتماعية والسياسية في كثير من مناطقه. وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، تحولت الزعامات القبلية والطرق الصوفية والمجتمعات الريفية إلى كيانات مرجعية فاعلة في تشكيل السلطة وتحديد أنظمتها وهياكلها، بل وحتى توجيه التنمية وتوزيع الموارد، وفق رؤاها المحلية، لا وفق منطق الدولة القومية. وقد امتد تأثير هذه المرجعيات إلى صناعة القرار السياسي نفسه، حيث يعتمد كثير من القادة على التحالفات القبلية والطائفية للبقاء في السلطة أو الوصول إليها.
منذ الاستقلال عام ١٩٥٦، حاولت النخب السودانية تأسيس دولة حديثة تقوم على المواطنة والدستور والمؤسسات والعدالة. لكن هذه المحاولات غالبًا ما اصطدمت بواقع اجتماعي غير مهيأ لقبولها، أو سقطت في فخ الشعارات النخبوية غير المتجذّرة شعبيًا، فظلّ المجتمع – خاصة في الأطراف – بعيدًا عن مشاريع التحديث التي بدت غريبة، بل أحيانًا معادية لقيمه وموروثه. وقد ساهم في ذلك أيضًا الجمود الديني والتدين التقليدي، وعجز الخطاب الفقهي عن إنتاج رؤية قادرة على التفاعل مع متغيرات العصر والتقدم العلمي والتكنولوجي، مما خلق فراغًا بين الإلهام الديني والواقع المعاش.
أما بالنسبة لمظاهر الصراع بين الحداثة والموروث، فيمكن رصد التوتر بين الحداثة والموروث في عدة مستويات:
تشريعيًا: كالصراع حول قوانين المرأة، وتطبيق الشريعة، والحريات الفردية.
إداريًا: في هيمنة المحاصصات الجهوية والقبلية على التوظيف وتوزيع الموارد.
رمزيًا: في الخلاف حول اللغة الرسمية، النشيد الوطني، والعَلَم.
وقد أدى هذا التوتر إلى هشاشة البنية السياسية، وسهولة اختراقها من قِبل الميليشيات، أو الحركات المسلحة، أو القوى الإقليمية المتربصة، ما أضعف الدولة المركزية وفتح الباب أمام صراعات الهوية، والانفصال، كما حدث في جنوب السودان، وما قد يتكرر في مناطق أخرى.
هل ما زلنا نتخبط بين التقليد الأعمى والتغريب الكامل، إذ إن الحل لا يكمن في إلغاء الموروث أو تقليد النموذج الغربي بشكل أعمى، بل في البحث عن صيغة وطنية وسطية تنبع من خصوصية الواقع السوداني. من بين تلك الصيغ:
الاعتراف الدستوري بالتعدد الثقافي والديني واللغوي، لا بوصفه تهديدًا، بل باعتباره رصيدًا وطنيًا.
منح المجتمعات المحلية سلطات حقيقية ضمن نظام اتحادي، يخفف الاحتقان مع المركز.
فصل الدين عن الدولة بأسلوب لا يستعدي المتدينين، ولا يمس الوجدان الشعبي.
إصلاح التعليم والإعلام لترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن، لا للطائفة أو العشيرة.
إنتاج نخبة سياسية جديدة تتجاوز الولاءات الضيقة وتوازن بين الأصالة والمعاصرة.
وفي خاتمة المقال الجدلية نقول إن السياسة السودانية تقف اليوم في مفترق طرق خطير: إما أن تظل أسيرة الموروث والتقليد، وتواصل الانهيار، أو أن تنجح في بلورة نموذج وطني عقلاني متوازن، يستوعب إرث الماضي دون أن يغرق فيه، ويستلهم قيم الحداثة دون أن يفقد هويته. هذا التحول لن يتم دون إرادة سياسية حقيقية، وتوافق وطني واسع، وقيادة تؤمن بأن بناء الدولة الحديثة لا يتم ضد المجتمع، بل عبره ومن داخله. نتمنى أن تتاح إدارة نقاش هادف وبنّاء يساهم في تمهيد الأرض لسودان جديد، أكثر وعيًا، أكثر عدلاً، وأكثر قدرة على التقدّم.